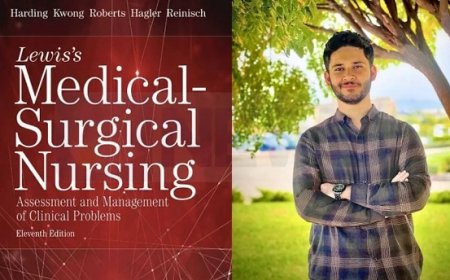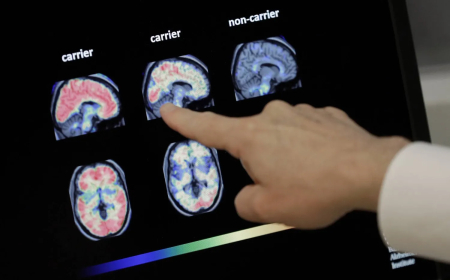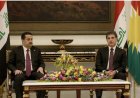أي جيل نطمح لبنائه؟
في ركن صغير من هذا العالم يجلس طفل يتأمل لعبة خشبية متشابكة، أو يكوّن بأصابعه الصغيرة برجاً من المكعبات الملونة، عيناه تلمعان بفضول طفولي لا حدود له، وأصابعه تصوغ عوالم جديدة بألوانها وأشكالها. هذا المشهد البسيط، في ظاهره، يحمل بين طياته بذور التغيير وقوة الأحلام التي قد تشكل مستقبلاً أكثر إشراقاً.

هؤلاء الأطفال، بفضولهم الطاغي وأسئلتهم التي لا تنتهي، هم نواة الغد، بين ألعابهم الصغيرة وأحلامهم الكبيرة يكمن سر الحياة وقصتها المستمرة. لكن السؤال هنا كيف نرعى هذا الفضول؟ كيف نحول تلك اللحظات العابرة إلى فرص لبناء إنسان متكامل يحمل القيم والمعرفة والإبداع؟ يبدأ الجواب من حيث تبدأ كل البدايات العظيمة: التربية والتعليم. التعليم ليس مجرد دروس تُلقَّن أو معارف تُحفظ، بل هو عملية بناء إنسان، حين نعلم الأطفال القيم والأخلاق النبيلة ونربيهم على احترام الآخرين وتقدير التنوع، فإننا نزرع فيهم أساسيات التعامل الإنساني السليم ونمهد الطريق لنشأتهم على وعي عميق بأن التنوع العرقي والديني والثقافي ليس مجرد واقع، بل هو مصدر قوة وإلهام لبناء مجتمع أكثر انسجاماً وتسامحاً. كذلك، فإن غرس قيم المساواة منذ الصغر، وتعليم الأطفال أن المرأة والرجل شركاء متساوون في بناء الحياة، يضع الأساس لمجتمع عادل ومزدهر. التعليم الحقيقي لا يتوقف عند حدود الفصول الدراسية، بل يتسع ليشمل التجربة العملية، حين نُشرك الأطفال في أنشطة مجتمعية وبيئية كمساعدة محتاج، وزرع شجرة، وتنظيف شارع، وحماية البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة، فإننا لا نغرس فيهم فقط شعوراً بالمسؤولية والانتماء، بل نفتح أمامهم آفاق التفكير الخلّاق. هذه التجارب الصغيرة تساهم في تشكيل عقولهم لتكون قادرة على الإبداع والتخيل، ويصبحون قادة يحملون على عاتقهم رفعة مجتمعاتهم وحمايتها. أي جيل نطمح لبنائه؟ هذا السؤال يُعد من أكثر الأسئلة أهمية في مسيرة بناء المجتمعات، إذ إن تحديد المواصفات المطلوبة في الجيل القادم يساعدنا بشكل كبير على رسم معالم الاهتمامات التي سنغرسها في نفوس أبنائنا، ونوعية السلوكيات التي سنوجههم نحوها، إضافة إلى الأفكار والمعارف التي سنحفزهم على استيعابها. يشهد النظام التعليمي في العراق كافة ازدواجية صارخة بين المدارس الحكومية والأهلية، حيث تقف الأولى مكبّلة بقيود قلة الموارد وضعف البنية التحتية، فيما تنعم الثانية بامتيازات المناهج الحديثة والكوادر المؤهلة، ولكنها تظل حكراً على القادرين مالياً. هذه الفجوة لا تكرّس التفاوت الطبقي فحسب، بل تعيد إنتاجه، فتتحول المعرفة من حق مشاع إلى امتياز، ويغدو المستقبل مرهوناً بالقدرة على تحمل كلفة التعليم. نتيجة لذلك، يتأثر الطلاب الذين ينتمون إلى أسر ذات دخل محدود في فرصهم المستقبلية، حيث يواجهون صعوبة في المنافسة على فرص العمل التي تتطلب مهارات ومعرفة متقدمة. وهذا التفاوت لا يؤدي فقط إلى ضعف قابلياتهم في سوق العمل، بل يعمّق من فجوة البطالة ويزيد من احتمالية تهميشهم اقتصادياً واجتماعياً. إن استمرار هذه الازدواجية دون إصلاح جوهري يهدد بإضعاف الحراك الاجتماعي وتكريس فجوات تنموية يصعب تجاوزها. لتحقيق نهضة تعليمية شاملة تسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع، يتطلب الأمر تكاتفاً من جميع الأطراف. الحكومة عليها أن تتبنى سياسات تعليمية تهدف إلى ضمان توفير فرص تعليمية متساوية لجميع الأفراد بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية، والاقتصادية، تبدأ بتحسين البنية التحتية للمدارس، من خلال بناء المزيد من المؤسسات التعليمية المجهزة بتقنيات حديثة لتلبية احتياجات الطلاب. يجب أيضاً تخفيض أعداد الطلاب في الصفوف الدراسية، مما يوفر بيئة تعليمية مريحة تُمكّن الطلاب من التركيز. إلى جانب ذلك، ينبغي للحكومة الاستثمار في تطوير المناهج لتواكب التحديات العصرية، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي. كما أن تحسين ظروف المعلمين وضمان حقوقهم الوظيفية والاجتماعية يُعد أمراً بالغ الأهمية لضمان استقرار العملية التعليمية. من جانب آخر، يقع على عاتق المعلمين دور رئيسي يتمثل في تقديم التعليم بأساليب مبتكرة تحفز الطلاب على التفكير والتفاعل، عليهم أن ينتقلوا من أسلوب التلقين إلى أسلوب التمكين، كما يجب أن يكونوا قدوة أخلاقية يحتذي بها الطلاب، مع التركيز على غرس قيم الاحترام، والتعاون، والتسامح. من جانبها، تُعد الأسرة الأساس الأول لبناء شخصية الطفل، عليها أن تدرك أن دورها لا ينتهي عند إرسال الطفل إلى المدرسة، بل يمتد إلى دعمه نفسياً وعاطفياً، وتحفيزه ومساعدته على استكشاف مواهبه واهتماماته. كما أن الحوار المستمر مع الأبناء حول القيم الإنسانية والتحديات التي يواجهونها في حياتهم الدراسية يُسهم في بناء وعيهم ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة. وأخيراً، يمكن تعزيز هذا الجهد المشترك من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوفير التمويل اللازم للتطوير، وتنظيم برامج تدريبية للمعلمين، وخلق فرص جديدة للطلاب تُمكّنهم من تطبيق ما يتعلمونه في بيئة عملية. بهذه الجهود المتكاملة، يمكننا ضمان إعداد جيل واعٍ يحمل مشاعل التغيير نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً. لقد أدركت بعض الدول أهمية هذا الاستثمار في الأجيال الصاعدة، فوجهت مواردها لبناء منظومات تعليمية تحتضن الأطفال وتغذي عقولهم. على سبيل المثال، اليابان بعد دمار الحرب العالمية الثانية وقصف "هيروشيما" و"ناغازاكي"، نهضت بنظام تعليمي جديد ساهم في استعادة قوتها. كما أن فنلندا، نجحت في إحداث ثورة تعليمية قلّصت الفجوات بين الطلاب واعتمدت على تقليل الواجبات واختبار إلزامي وحيد في سن 16. وتميزت سويسرا، بتعدد لغاتها الرسمية في التعليم، مع تركيز 95% من الطلبة على المدارس الحكومية. أما بلجيكا، فتقدم أربعة أنظمة تعليمية ثانوية متنوعة لتلبية اهتمامات الطلاب مع تعليم حكومي متميز. والنتيجة كانت تحول هذه الدول إلى نماذج يُحتذى بها في التقدم الاقتصادي والاجتماعي. هذا النجاح يثبت أن كل دينار يُنفق على تعليم الطفل هو بذرة تثمر مستقبلاً مشرقاً للأمة بأكملها. أمامنا فرصة لنصنع تغييراً حقيقياً، إن كل طفل هو عالم صغير يحمل في داخله احتمالات لا نهائية. فلنكن نحن اليد التي ترعى تلك العوالم، والكتف الذي يسند خطواتهم الأولى، والصوت الذي يقول لهم: "أنتم الأمل." حينها فقط، سنرى أحلامهم تتحول إلى إنجازات، وأيديهم الصغيرة تبني جسوراً نحو غد زاخر بالأمل والتطور.
(راواند عبدلقادر درويش و زهراء كوسرت ظاهر)
راواند عبدالقادر، بكلوريوس اداب لغة انكليزية، ماجستير (اعلام و علاقات العامة) من الجامعة الامريكية، واشنطن – الولايات المتحدة، متمرس في مجالات العلاقات و التنمية. من اربيل كوردستان العراق، عمل في القطاع الانساني و الحكومي في اقليم كوردستان العراق.
زهراء كوسرت ظاهر بكالوريوس لغة عربية وماجستير في النقد والأدب العربي، أكاديمية تعمل في كلية اللغات جامعة صلاح الدين- أربيل.